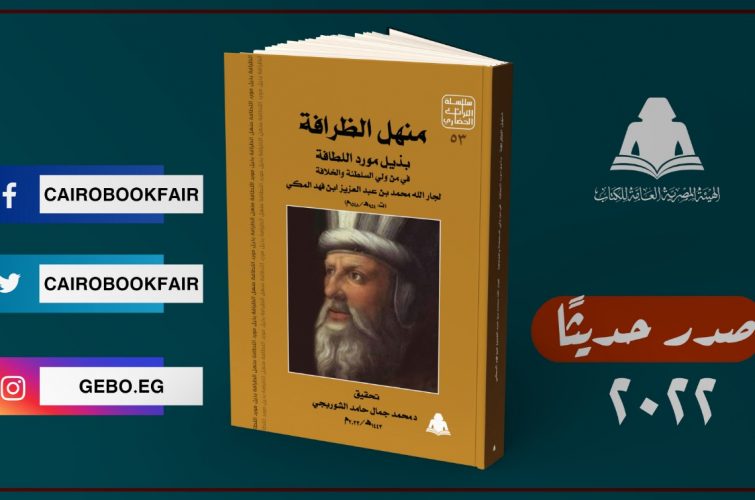شاركت رواية “طرح النهر”، للكاتب الطبيب حاتم رضوان، بدورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الفائتة، بطبعتها الجديدة الصادرة عن دار أكوان للنشر والتوزيع.
تدور الرواية في إطار رومانسي اجتماعي، يغلب الوصف على أحداثها، وتتسم لغة السرد بالبساطة والشاعرية، حيث معظم أحداثها الواقعة بين مشاهد الريف الآسرة وعلى ضفاف نهر النيل.
وينشر الموقع الإخباري الرسمي لهيئة الكتاب جزءا من رواية “طرح النهر”، للكاتب حاتم رضوان.
“يتلألأ ماء النهر في عينيه، لا تستره هذه الأبنية والكازينوهات، حجبته الآن، يرى الضفة المقابلة شريطًا أخضر، ينتهي في الأفق البعيد. تلمع عينا إيمان عبدالمجيد في المدرج، نجمتين حاول الإمساك بما فيهما من معانٍ، ابتعدتا هناك في المدينة البعيدة، لتُخَلِّفَاه وحيدًا، ينظر في استدارة الميدان الذي تركه للتو خلفه، في العربات المارقة بجواره، في هذا الطائر الصغير، يحلق عاليًا في السماء، في أسلاك الكهرباء فوقه، في النهر، في اللاشيء.
جلس على مقعد حجري، أخرج صورتها من جيب ذاكرته، عينان خضراوان وشعر كستنائي ناعم ولامع، يصل حتى رقبتها، مصفف للخلف في بساطة واعتناء، ترتدي فستانها المفضل لديه والمنقوش بورود صغيرة ذات ألوان مختلفة ومتجانسة.
كثيرًا ما كرر لنفسه: قلبي حجر… من تستطيع أن تنحت صخره… أن تخترق حجارته؟ له فلسفة خاصة وراسخة، لم تمتلكه فتاة من قبل، ولم يتحكمْ فيه قانون.
أخرج صورتها ونصبها بين عينيه والنهر، لا يفصله عنه غير هذا السور الواطئ من الحجر الأبيض والحديد، مد يده إلى أرض الرصيف تحته، قبض على عدد من الحجارة الصغيرة والمستديرة، رمى حجرًا فثانٍ فثالث، عشرون حجرًا تأخذ طريقها إلى قاعه، وهو جالس مكانه يحدق في عيني إيمان عبدالمجيد، في النهر، في اللاشيء، تردد داخله السؤال: لماذا… لماذا كانتا لون النهر؟ لون عينيّ عم جاد، يهيم بنظرتهما في البعيد، إلى الشاطئ الآخر أم إلى الماضي من حياته، يستند بظهره إلى جدار غرفته الخشبية، ينزلق بيده على صلعته المميزة، يمرر أصابعه، يداعب شعيرات شاربه الكث. يرى فيهما نادر مسحة حزن وغموض وانكسار.
كثيرًا ما خايلته هذه الصورة عبر سنينه الفائتة، مثلما تخايله الآن، لا يعرف متى رآه أول مرة. كانا جالسين هو وحسن البمبي مكانهما المفضل، فوق هذا الجزء المنحدر من ضفة النهر، يصطادان السمك، كان قادمًا من ناحية الزراعية القديمة، يحمل على كتفه جوالًا مهترئًا، أنزله وراح ينظر حوله، جس الأرض بقدميه، رفع رأسه إلى السماء، أدار ظهره للنهر، وصلى ركعتين، سلَّم، ثم رفع يديه إلى وجهه، مسحه بهما، ثم قام، ترك جواله، وعاد من حيث أتى، التفت حسن البمبي إلى نادر عثمان:
ـ تيجي نشوف إيه جوه الشوال؟
ـ لا يا عم … أحسن يكون قتيل.
يومًا وراء يوم كانا يراقبانه، يأتي بكتل خشبية من ناحية السكة الحديد المهجورة، يرصها الواحدة فوق الأخرى، مكونًا أربعة جدران، وتاركًا فراغين، أحدهما في الخلف سوف يضع مكانه بابًا، والآخر يبص على النهر، سَيُرَّكِبُ فيه شباكًا، في أيام تالية أتى بمجموعة من الصفائح القديمة، شقها، وفردها، وثبتها أعلى الجدران، لتصنع سقفًا للغرفة التي ظلت إلى يومه هذا مكانها، لم تتغير، رغم اختفاء عم جاد، وتغير كل ما حولها، وإنْ عشش في أركانها وحولها العنكبوت، وسكنتها الحشرات والهوام.
نهض نادر عثمان من فوق المقعد الحجري، استند بيديه على السور الحديدي، تردد في أذنيه صوت إيمان عبدالمجيد، وهي تخبره بأن أقارب لها يسكنون مدينته، وسألته في أي منطقة يسكن؟ سارع لسانه:
-التمثال.
سارا هو وهي مخترقين نفق الخليفة المأمون، اختصرا الطريق عبر الحرم الجامعي، وعند نقطة محددة التفتا معًا، وفي صوت واحد قالا: «قصر الزعفران»، وضحكا، وكان لضحكتيهما براءة زمان ولى ولن يعود، جلسا على سور النافورة المنخفض، تواجههما بوابته، حكى لها عن قصر عتيق يحتل أحد أطراف مدينته، تمر من أمامه السيارات، وتمامًا مثل هذا القصر أصبح الآن مقرًا لجامعة المدينة، كان لأحد أفراد الأسرة المالكـة «أظنه عباس الأول»، يأتي إليه من هذه المدينة – مدينتها، ومن قصر كهذا، يصطحب معه غلمانه، لكي يستجم فيه، كانت الأرض حوله جنائن وحقول، والمسافة بينه وبين النهر رغم طولها، لا يحدها عمران، في الغرب تقع المدينة القديمة، وخلفه في الشمال الشرقي تقع أطلال مدينة أتريبس الفرعونية، اختفت على مر السنين تحت الزراعات، وزحف المباني المنشأة حديثًا، لم يبق منها غير بقايا تلال قليلة شرق المدينة الحالية، أطال في الحكاية، واستنتج، وأكد لها كم كانت العلاقة بين مدينته ومدينتها قوية منذ قديم الأزل، ضحكت: «عارفة وربنا يستر فاكرة إنه قُتِلَ فيه، ومن يومها لم يسكنه أحد من أفراد أسرته». أشارت نحو قصر الزعفران: «من حوالي سبعين سنة كان جدي مصطفى الأزهري.. يدرس هنا.. أيامها كان القصر اسمه مدرسة فؤاد الأول». ثم سكتتْ.
كانت كلما جلست أو مشت، تحني رأسها للأمام، وكأنها تقتفي خطوطًا مرسومة، لا تريد أن تحيد عنها، وإذا تكلمت لا أن تنظر مباشرة في عيني من تكلمه، رفعت عينيها إليه قليلًا، تبادلا نظرات خاطفة وعابرة، طفرت إلى شفتيها ابتسامة خجل، وسارعت تخفض رأسها مرة أخرى، تداري وجهها في الأكلاسير، يحمل على إحدى وجهيه صورة طفلة ذات شعر أصفر، ولها عينان خضراوان، تنظران إلى زهرة أرجوانية اللون تحملها في يدها: «حلوة هذه الطفلة.. إنها تشبهك كثيرًا». جاوبته بصمت يصل الصمت، واصل كلامه: «تشبهين كليهما»..
أشاحت مستفهمة. قال: «الطفلة والزهرة». انتفضت واقفة، وقد تحول وجهها إلى اللون الأحمر. قالت: «نمشي». قال لها: «أمرك»، ومضيا إلى محطة قطار كوبري الليمون”.
***
 شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..شبكة إخبارية تتيح مساحة جديدة للمعرفة والإبداع والرأي حول العالم..
شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..شبكة إخبارية تتيح مساحة جديدة للمعرفة والإبداع والرأي حول العالم..