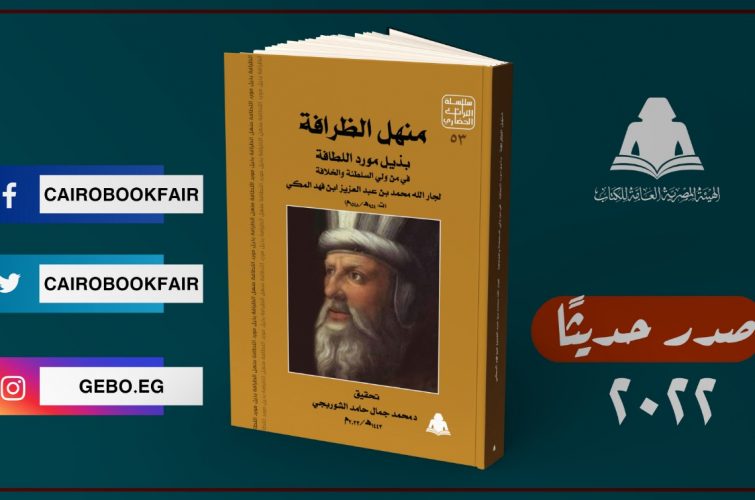لا يمكن لأحد أن يُنكر التراث الطويل، والتاريخ الثرى للسينما المصرية، تلك الصناعة الرائدة التى شكلت وعى وثقافة وذاكرة مئات الملايين من متحدثى اللغة العربية على مدار عقود، حتى وإن تراجع هذا الدور خلال الأعوام الأخيرة لأسباب عدّة. إلا أن تقديرنا لهذا الماضى الحافل لا يمنع إعادة النظر والتحليل والتقييم، بل إنها ممارسات تنبع بالأساس من الاعتزاز بالتاريخ السينمائى والرغبة فى الاشتباك معه بشكل خلّاق.
أكتب هذه المقدمة بمعرض الحديث عن اثنتين مما يُمكن تسميتها بالأساطير المؤسسة للسينما المصرية: الأقوال والآراء والادعاءات المتداولة والمتكررة بصورة تجعل الوعى الجمعى يتعامل معها باعتبارها حقائق، فيغدو من المعتاد أن تجرى على لسان النقاد والمحللين والمؤرخين فى برنامج تليفزيونى أو حوار صحفى أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يُكلف أحدهم نفسه بالعودة للوثائق أو حتى القيام ببحث بسيط على الإنترنت للتأكد من صحتها.
الأسطورتان هما الريادة التاريخية والمجاراة الفنية. الأولى ترتبط بتأسيس السينما فى مصر، حيث صار من المألوف والمكرر أن نسمع أن مصر من أول الدول التى عرفت السينما، بل ويضعها البعض بثقة فى الترتيب الثانى أو الثالث تاريخيًا بين الدول التى وصلها اختراع الأخوين لوميير. أما الأسطورة الثانية فترتبط بالمستوى الفنى للأفلام، فلا يمر شهر دون أن نرصد من يذكرنا بأن السينما المصرية كانت تكافئ هوليوود فى المستوى يومًا ما، وأن الطفرة التقنية والتوزيعية هى ما خلقت البون الشاسع الحالى «ومعها خطايا الأجيال الأحدث طبعًا»، بينما كانت أفلامنا فى عصرها الذهبى تجارى السينما العالمية وتسير معها كتفًا بكتف.
حسنًا، هذا المقال يحاول نفى الزعمين السابقين. ولا فترة زمنية تصلح لتوضيح تهافت الأسطورتين مثل عشرينيات القرن العشرين، العقد الذى عاشت فيه مصر فورة ثقافية وفكرية وفنية، كانت نشأة فن السينما أحد صورها. ولاحظ هنا أننا نتكلم عن إرهاصات النشأة لفن كان جنينيًا، احتاج عقدًا كاملًا قبل أن يصير صناعة، كما سنرى خلال الفقرات التالية.
التأسيس.. لوميير بين العرض والتصوير
أقام مهرجان القاهرة السينمائى عام 1996 احتفالًا بعنوان «مائة سنة سينما» كرّس للاعتقاد الراسخ بأن عمر السينما المصرية تجاوز القرن. وهو ما ينطلق من معلومة صحيحة، لكن يجب توضيحها ووضعها فى سياقها، خاصة مع ما يتيحه لنا الإنترنت من مصادر ربما لم تكن متوفرة قبل ربع قرن. التاريخ يرتبط بما وثّقه الناقد والمؤرخ أحمد الحضرى حول استضافة بورصة طوسون «كافية زواني» عرضًا لأشرطة من إنتاج شركة سينماتوغراف لوميير بتاريخ 5 نوفمبر 1896. لكن هل عرض بعض الأفلام لمشاهدين لا يعرفون ماهية السينما يمكن أن تُعد بداية للسينما فى مصر؟ أو أن تضعنا فى موضع الريادة؟
للإجابة نبغى النظر لتاريخ أكثر أهمية، وهو رحلة المصور ألكسندر برومبيو، مصوّر سينماتوغراف لوميير إلى مصر، التى قام بها ليصوّر شرائط من الحياة المصرية لحساب الشركة. كاتالوج لوميير المتاح بأدق التفاصيل عبر الإنترنت يخبرنا أن رحلة برومبيو تمت فى الفترة بين 9 مارس و25 أبريل 1897، قام خلالها بتصوير 37 شريطًا لا تتجاوز مدة كل منها الدقيقة، فى القاهرة والإسكندرية وسقارة وبنها ونهر النيل، أول شريط منها صوره لحظة وصوله إلى ميناء الإسكندرية ليحمل الرقم 359 فى الكاتالوج الزمنى للشركة.
وبمراجعة الكاتالوج نفسه نعرف أن مصر كانت الدولة رقم 15 التى تزورها كاميرا السينما، وأن شرائط لوميير لم تلتقط شوارع فرنسا وبريطانيا وروسيا فقط قبلنا، ولكنها وصلت لدول عربية أخرى مثل الجزائر التى صوّر فيها الشريط رقم 19 وتونس الشريط رقم 206، وكلاهما خلال العام 1896. أى أننا وبينما نفخر بعرض عدة أفلام فى مقهى، كانت كاميرا السينما تصور لقطات فى 14 دولة أخرى، أغلبها لا يزعم أن تاريخه السينمائى يتجاوز القرن وربع القرن!
المجاراة.. هل نافسنا هوليوود؟
نقفز زمنيًا إلى عقد العشرينيات، موضوع هذا العدد الذى شهد ثلاثة أحداث رئيسية فى تاريخ السينما المصرية: تصوير أول فيلم روائى قصير «برسوم يبحث عن وظيفة» للمخرج محمد بيومى عام 1923، تصوير أول فيلم طويل على الأراضى المصرية لصنّاع أجانب «فى بلاد توت عنخ آمون» من إخراج الإيطالى فيكتوريو روسيتو عام 1924، ثم عرض أول فيلم روائى طويل مصري، وهو «ليلى» الذى بدأ إخراجه وداد عرفى ليتركه فيكمله ستيفان روستي، والذى أقيم عرضه الأول ليلة 16 نوفمبر 1927 لتكون ليلة فاصلة فى تاريخ السينما المصرية، هى الليلة التى يمكن رصدها حقًا نقطة لانطلاق السينما، أو لنقل عام 1923 وقت عرض برسوم، وهو ما يأتى كما هو واضح بعد ثلاثة عقود كاملة من 1897، ويجعل الاحتفال الحقيقة بمئوية السينما المصرية لم يحن بعد.
هذا التاريخ مبكر جدًا بشكل يثير الإعجاب قياسًا لبلاد العالم الثالث، أما لو قارناه بتطور السينما عالميًا فسنجد نفسنا فى كثير من الحرج، فالأمريكى جريفيث كان قد أطلق فيلمه الشهير «مولد أمة» مؤسسًا لفن المونتاج عام 1915، ليأتى السوفييتى إيزنشتاين ويغير قواعد هذا الفن فى «المدرعة بوتمكن» عام 1925. كانت السينما الوثائقية قد ترسخت بفيلم فلاهرتى «نانوك الشمال» عام 1922، وأصبح الرعب فى العام نفسه نوعًا مستقلًا له أدواته عبر «نوسفيراتو» لمورناو فى العام نفسه. كان تشارلى تشابلن وباستر كيتون رسخا مدرسة الكوميديا الحركية، وفى 1927 نفسه أطلق فريتز لانج «ميتروبوليس» ليفتح الباب لسينما الخيال العلمي.
لاحظ هنا أننا نتكلم عن كلاسيكيات حقيقية، يمكن حتى يومنا هذا مشاهدتها والاستمتاع بها كتحف فنية بخلاف قيمتها التاريخية، بينما كانت الهواة فى مصر يجربون استخدام الكاميرات للمرة الأولى، عبر ارهاصات بدائية احتاجت قرابة العقد حتى تُسفر عن أفلام قيمة يمكن اعتبارها من الروائع. فربما كانت الرائعة السينمائية المصرية الخالصة الأولى هى «العزيمة» لكمال سليم عام 1939.
هل هذا يعيب السينما المصرية أو يقلل منها؟ بالطبع لا، لكن معرفة التاريخ الحقيقى وإبرازه هو أفضل احترام لائق يُقدم لصُنّاعه، والابتعاد عن الأساطير الشوفينية أمر يليق بالعقلاء، لاسيما إن كانوا يمتلكون تاريخًا حقيقيًا يستحق الفخر. أما أبرز ما تخبرنا به قصة نشوء السينما وتطورها فى مصر «بل وفى العالم كله»، فهو أنها فن جوهره الحرية والمبادرات الفردية، صاغ تاريخه فى كل مكان مجموعة من المغامرين الذين صاروا يعرفون فى عصرنا برواد الأعمال. فنانون وفنانات استثمروا ما جمعوه طيلة حياتهم فى فن حديث قد الاستكشاف، فصنعوا تاريخًا وقدموا ابتكارات وحولوا المغامرة صناعة وطنية يتم تصدير إنتاجها بالكامل خارج البلاد.
السينما فن وليد الحداثة والحرية، قرين التطور التكنولوجى والاستثمار الجريء والحراك الفكرى والفني، وكلها أمور عاشتها مصر آنذاك فأطلقت صناعة نفخر بها الآن وإن كشفنا أساطيرها المؤسسة. صناعة حرة غير احتكارية لا يمكن أن تستقيم لو تدخلت فيها أيادى الحكومات وكبلتها قيود الرقابة الرسمية والمجتمعية. صناعة كانت رائدة ونحلم أن تعود كذلك.
*المقال منشور بجريدة القاهرة
 شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..شبكة إخبارية تتيح مساحة جديدة للمعرفة والإبداع والرأي حول العالم..
شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..شبكة إخبارية تتيح مساحة جديدة للمعرفة والإبداع والرأي حول العالم..