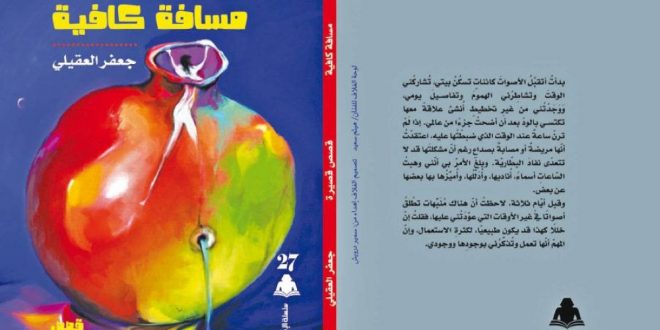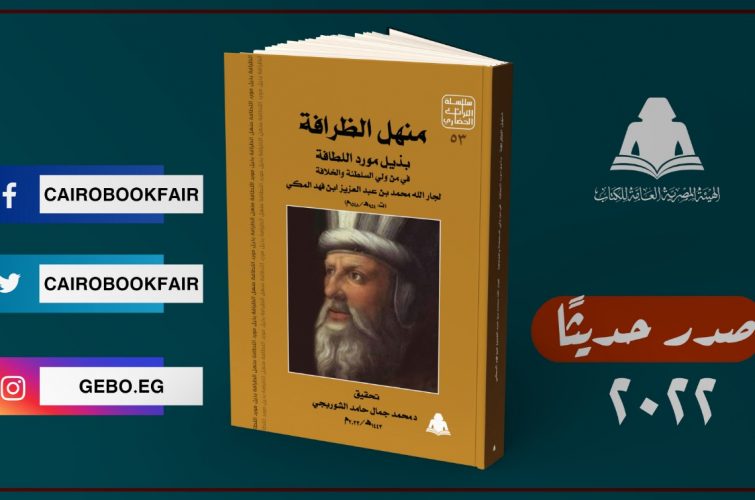ينشر الموقع الإخباري الرسمي لهيئة الكتاب “المعرض” قصة “علامة فارقة” للكاتب الأردني جعفر العقيلي، والذي أهداها لجمهور الثقافة في مصر والعالم العربي، ويشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يناير المقبل وتحل خلاله المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.
العقيلي له مجموعة قصصية بعنوان “مسافة كافية” صدرت مؤخرا ضمن سلسلة الإبداع العربي عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهو كاتب وصحفي وناقد ومدير تحرير الدائرة الثقافية والمشرف على ملحق الرأي الثقافي بصحيفة الرأي الأردنية، ويشرف على عدد من المنتديات والصالونات الثقافية، بخلاف فوزه بعدة جوائز.
“علامةٌ فارقة”
هكذا انتبهتُ إليها؛
كنت أمشّط شَعري أمام المرآة، ومصادفةً رأيتُها تختطّ طريقاً غير تلك التي درجتْ عليها رفيقاتُها.
لم آبَهْ للأمرِ في بادئِه. ثمّ حين واجهَتْني بحضورِها المشاكس، اغتظتُ. ولأنني لستُ عدوانياً، بخاصة مع «كائن» في مملكة جسدي، قلتُ في سـري: «السقوطُ مصـيرُها لا محالة»، فهذا ممّا يحدث يومياً، من دون أن نحسَّ أننا فقدنا شـيئاً ذا قيمة.
لكنها، على خلاف ما توقّعتُ، بدت ملأى بالحيوية مساءً، وكأنّما تتسلّق الهواءَ في حركةٍ رياضـية مدرّبة. تتبّعتُها وما انصـرفَ نظري عنها، وأكذبُ لو ادّعيتُ إنّني كنت راضـياً عمّا يجري، لكنها، تلك الشَّعرة ذات العنفوان، نجحت بِقُدرةِ قادر في استئثار اهتمامٍ منّي ما كنتُ لأمنحه لأمرٍ آخر.. ورأيتُ في انحناءتِها اللطيفة إلى أعلى ما يمكن أن يدفع إلى التفَكُّر.
«إنها شَعرة حكيمة»، قلتُ لصديقي الذي حاول انتزاعها من حاجبي على غفلةٍ مني، وأضفتُ: «دَعْها، فشأنُها شأني»، فما كان منه إلّا أن ردّ مازحاً على عادته: «إنَّ من الشَّعر لَحِكمة».
ذلكَ في اليوم التالي لاكتشافي إياها، وفيه شعرتُ أنني مسؤول عن بقائها، وأن عليّ المنافحة عنها كي تظلَّ على قيد التمرُّد، تلك الشَّعرة التي بدأت تكتسبُ «غَلاظةً»؛ في الحجم لا في السلوك، وتنحرفُ شـيئاً فشـيئاً في مسارها الذي لا يتجاوز سنتيمتراً واحداً.
أصبحتُ أتعامل معها على أنّني أعرفُها خيرَ معرفة؛ ورأيتُها تجسّد كائناً مختلفاً التقيتُه في محطةٍ ما على ضفاف العمر، قبل أن نتوادَع.. لذا راقتْ لي فكرة أن استئنافَ علاقتنا الآن هِبَةٌ ربانية، فما أحوجني إلى حدثٍ استثنائي يعيدني إلى الكتابة أو يعيدها إليّ.. وهذا على الأرجح ما فعلته «ابنةُ الكلب» هذه.
ولستُ أكشف سـراً أنني رغم ذلك، حاولتُ إعادتَها إلى السـربِ الذي غادرتْ، بخاصة في بواكير علاقتِنا، لكنني وأنا أتأمّلها وأرصدُ تحوّلاتِها، رسختْ لديّ قناعةٌ بخروجها عن الطوع إلى غير رجعة، وتيقّنتُ أنها حسمتْ خيارَها، فأُعجبتُ بموقفِها.
لكن قلّة الطواعية التي أبْدَتْها للتساوق مع ما حولها، دفَعتْ زوجتي إلى «النّرفَزة»، وهي تسبّل حاجبَي كما تفعل لابننا البكر حين يفلت عقالُ شَعرِه ويعوزه الانتظامُ بعد الاستحمام. لم تستجب الشَّعرةُ لمحاولات إعادتها إلى «بيت الطاعة»، فظهرتْ بوادرُ النقمة على محيّا زوجتي، وانقضّت عليها كأن بينهما خصومة عتيقة.
إزاء الموقف الدرامي المتصاعد، من الطبيعي ألّا أصمت، فالأمرُ يتعلّق بي في المقام الأول! لذا فاجأتُها أهدّدُ بسبّابتي: «إنها مسألة حياة أو موت!»، وأضفتُ خافضاً من وتيرة صوتي كأنّما أؤدّي دوراً مسـرحياً: «من حقِّها أن تعزف سـيمفونيتها على هواها، ولا بد أن نتقبّل هذا».. وأمعنتُ في الدَّور قائلاً: «لقد استوتْ على عرشِ تمرُّدها. لِنَكُن حضاريّين معها يا عزيزتي».
وسط ذهولٍ غرقَتْ في لجّته، زدْتُ زوجتي من الشِّعر بيتاً: «رباطٌ وثيقٌ بيننا، ويصعب تخيُّل أنني سأتخلّى عنها.. دعيها هداكِ الله».
رمقَتني بطرفِ عينها، ووجهُها يتحول إلى علامة استفهام كبيرة، قبل أن يطفو على ملامحها يقينٌ عازَني فَهمُه: «هيَ قصةٌ جديدة إذن!»، وانصـرفتْ بابتسامةٍ هازئة، وقد غاظَها اكتفائي باللاتعليق.
في خلوَتي، وجدتُني متلبّساً بملاطفَةِ شَعرتي فيما كنتُ أفكّر بمسألةٍ تُهِمُّني. يبدو أنها غيّرت من عاداتي. وعلى سبيل التوضـيح، لم أعد أطقطق الأصابع منذ نهرني أبي في طفولتي، وتحولتُ في اليفاعة إلى شاربَين نبتا للتوّ أداعبهما إذا ما أشغلني أمر. واصلتُ ذلك زهاء ربع قرن، بعلانيةٍ وبلا حرج، بعدما رأيتُ كثيراً من أقراني يثابرون على ذلك، طمعاً باستنبات معالِمِ الرجولةِ في وجوهِهم قبلَ أوانِها.
وعلى «كَبَرٍ» أيضاً، اكتسبتُ عادةً جديدة؛ تحريك لساني بحثاً عن بقايا طعامٍ لُكْتُهُ على عجل، ما يستوجب فتحَ فمي بشكل معْوَجّ. وهو ما نجحتُ في التخلُّص منه بعد عملياتِ ترميمٍ للأسنان جرت على مراحل.
.. أمّا أن أكون في اجتماعٍ مع مدرائي حيث أعمل، وأقبض على أصابعي تحاورُ الشَّعرةَ بمجرد سهوي عنها، فذلك ما عدَدْتُه «خارج المقبول».
انصـرفتُ عنها لأتأملَ «الشاليش» الذي تربّى عليه شَعرُ زملائي، فراعَني أننا في زمن «الشَّعر المُدَجَّن»، تصطفّ فيه الملايين في حركةٍ يطوّعها «الكْرِيم» و«البلسم» وسواهما.
ولأنني أيقنتُ أن الشَّعر مثل البشـر، التي ترفضُ البقاء في «القطيع» عُملةٌ نادرة، وجدتُني محقّاً في التمسُّك بها؛ شَعرتي التي أصبحتْ تَسِمُ حاجبي بالفرادة. وَقْعُها على العين كوَقْعِ وَحْمَةٍ لزميلتي تزيّن أسفل عنقها، أو «الثالولة» الراقدة بسلامٍ قرب شفة زميلتي الأخرى..
أُحِبُّها العلامات الفارقة، ويستهويني البحثُ عنها أكثر من العثور عليها.. كيف لا وهي التي كثيراً ما دوّخت التاريخ؛ أنف كليوباترا، شامة مارلين مونرو، فم إليسا المعْوَجّ، وقامة نابليون القصـيرة.. وها إني اهتديتُ أخيراً إلى خاصّتي: شَعرة في حاجبي الأيسـر.
«تلك العلامات لصـيقةٌ بأصحابها، لكن الشَّعرةَ التي جَنّنْتَنا بها، قد تقع في أيّ لحظة، فما الذي ستفعله حينئذ!»، هذا ما قاله صديقي إيّاه، فرددتُ عليه: «أقيم لها جنازة، وأفتح باب العزاء»، غيرَ عارفٍ، أكنتُ أمزح، أم قصدتُ ذلك وقد قَرَّ في لاوعيي، تقديراً لمكانتها ومناكفةً للمستخفّين بها.
أعرف أن الموت حقّ، فقررتُ البحث في Google عن حياةِ الشَّعر، وما وجدتُ سوى أن الإنسان يفقد مئة شَعرة يومياً دون أن يحسّ. عندها، دعوتُ الله أن يطيلَ عمرها، شَعرتي، وأن يُبقيها إلى جانبي حتى أنتهي من الكتابة.
وبلغَ بي الأمر تحسّباً لفقدانِها في حادث مفاجئ، أن التقطتُ صوراً لحاجبي وهي تتوسّطه بثقة، على سبيل الذكرى.
لكن، لا بُدَّ مما ليس عنه بُدٌّ. ففي يومٍ تلا، كانت زوجتي ستصحبُني لنباركَ لصديقةٍ لها اصطادت «عريساً لقْطَة». وقد استدعاها ذلك أن تُبدي اهتماماً لافتاً بما سأرتديه، فيما كانت الشَّعرة تتعربشُ الهواءَ، وتتأبّى أن تستريح وتريحني. وقد تسبّبتْ شقاوتُها في إرباكي، وأشغلَتْني بها، حتى ما عدتُ قادراً على التجاوب مع مقترحات زوجتي التي أرادتني «آخر شـياكة».
«أوووف. خلّصنا منها ياه..»، ورأيتُ ضـيقاً في عينيها، وهي تؤشـر بسبّابتها على الشَّعرة.
– تصـرفي كأنها غير موجودة. ولا تكترثي لها.
– أريدك أنيقاً في هذه الزيارة. عيب! ماذا يقولون؟ زوجته لا تعتني به!
– يا ليتَ حرصَكِ هذا من زمان. أم إنّ الأمر وما فيه، أن الغيرة من صديقتكِ تأكلُ قلبكِ. لن أرتدي سوى ما يُريحني. لستُ في منافسةٍ مع زوجها، كحالكِ معها. ولا يهمّني إن كان يملك خزنة قارون.
– أنا.. أنا تقول لي هذا. أنا التي أشتري فستاناً كل ثلاثة شهور، وهي تشتري واحداً كل أسبوع، وأَسْكُت. أنا التي قبلتُ بيومين في «العقبة» شهرَ عسل، وراحتْ هي على «تركيا» أسبوعين. أنا التي رضـيتُ بحظّي، وفوق هذا تقلب عيشتي بالنكد.
ثارتْ مرةً واحدة في وجهي، تلك التي لم ينقطع ثنائي على قناعتها وقبولِها بالقليل كي تسـير حياتنا برضا ومن دون ديون. كأنها قنبلة وانفجرت. وفيما كنتُ أحاول تهدئتَها واحتضانها بكلتا يديّ، أجهشتْ بالبكاءِ تُتابع:
– تحمّلتُ كثيراً.. تحمّلتُكَ وأنتَ تغفل عني في حضـرةِ أيِّ واحدة أخرى، «تدندل» آذانك لها، وتنساني كأنني غير موجودة، تزعّلني ولا تُطيّب خاطري.. وكلما فكرتُ بالحكي معك ترددتُ وقلتُ: مصـيره يعْقَل!
ووسط ذهولي و«طبطبتي» عليها، لاحتواء زوبعتها، واصلت تدفُّقَها:
– وفي الآخِر، قصة الشَّعرة! أعرف.. كلّ هذا لتلفتَ الأنظار إليك.
وجدتُني في حالٍ لا أُحسَد عليها، وظهرتُ ضعيفَ الحجّة دفاعاً عنا؛ أنا وشَعرتي، أمام بركانها الذي لم يهمد إلّا عندما خلعتْ ما كانت سترتديه للمناسبة، وجلستْ على طرف السـرير بتجهُّمٍ كأنما قررتْ صـرفَ النظر عن الزيارة.
تمددتُ على الطرف الآخر، وعلى إيقاع نهنهاتِها تفكّرتُ بما جرى. «تغارُ من شَعرة!»، ابتسمتُ في سـري، وأنا أتخيّلُها ضـرة لها.
بعد هدأةٍ قصـيرة حَسبْتُها نهايةَ الزوبعة، اقتنصتْ غفلتي وانقضّت عليّ. وقبل أن أتمكن من صدِّها، لوّحتْ بقبضتها مُحكمَةِ الإغلاق وزهوُ انتصارٍ يفيض من تعابيرها.
نهضتُ أركضُ نحو المرآة أطْمَئِنّ على شَعرتي، وضحكةُ شماتةٍ تطاردني.
إلهي وأنتَ جاهي؛ ألْهِمني الصبرَ، لأجتازَ محنتي وأواصلَ الكتابة.
 شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..شبكة إخبارية تتيح مساحة جديدة للمعرفة والإبداع والرأي حول العالم..
شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..شبكة إخبارية تتيح مساحة جديدة للمعرفة والإبداع والرأي حول العالم..