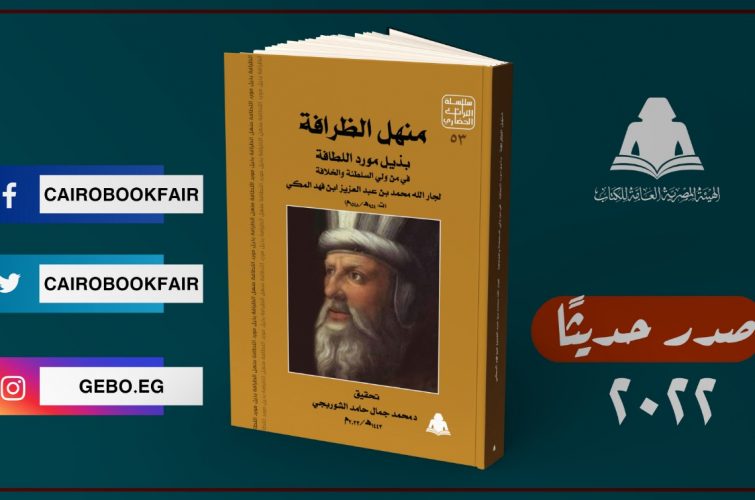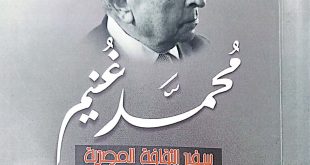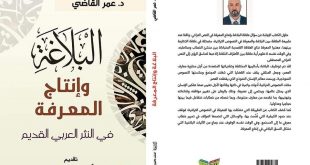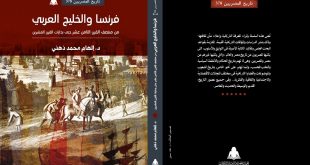صدر حديثا عن دار المفكر العربي للنشر ويديرها الزميلان الصحفيان حسام أبو العلا وأشرف رمضان، ديوان مشكاتي للدكتورة نورا حلمي، لتشارك به في الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يناير المقبل، ويتوافر بمكتبات دار المعارف.
ويقدم الناقد الدكتور شعبان عبد الجيِّد، قراءة حول الديوان تحت عنوان “الشعرُ في محرابِ الرجاء :
قراءةٌ في ديوان “مشكاتي” للشاعرة نورا حلمي” ينشرها الموقع الإخباري الرسمي لهيئة الكتاب:
***
لم أكن أتوقع حين أخذت أقرأ ديوان (مشكاتي) لِلشَّيْخةِ الدكتورة نورا حلمي أن يكونَ على هذا القدر من التأنقِ في التعبير والتفنُّنِ في التصوير؛ فأنا أعرف أن صاحبته متخصِّصة في القراءات وتعليم القرآن، ولها جملةٌ طيبةٌ من الكتب والمنظومات التي تدلُّ على رسوخ قدمها في هذا المجال. والمنتظر ممن هذا شأنهم أن يأتيَ شعرُهم باهتًا في لغته وضعيفًا في تخييله؛ وهو ما تأكد لي عكسَه تمامًا حين بدأت قراءة هذا الديوان، وسوف أثبته بالشواهد بعد قليل؛ فهو من أولى قصائده إلى آخرها يأخذك بما فيه من فنٍّ بديع، إيقاعًا وتخييلًا، ويعيدك ببناء قصائده إلى ما كان عليه الشعرُ في عصور قوته وازدهاره؛ دون أن ينفصلَ عن عصره أو يتجاهل ما جدَّ في ثقافته.
كيفَ نقرأُ النصَّ الأدبي ؟
من عادتي، حين أتناولُ عملًا أدبيًّا بالبحث والدرس، أن أقرأه ثلاثَ مرَّاتٍ على الأقل: مرةًّ لأستكشف عالَمَه الفنيَّ وأتعرف فكرته وموضوعه، والثانية لأستعيدَ تفاصيلَه وأتأملَ بنيته الجمالية، أمَّا الثالثة فتكون قبل أن أصدر عليه حُكْمًا أو أنتهيّ فيه إلى رأي. وغالبًا ما تكون القراءةُ الأولى ذاتيَّةً تأثريَّة؛ هي إلى الانطباع العَجِلِ أقرب منها إلى التأمل المستأني. ويقيني أن لها فعلَها في نفس المتلقي، وقد تخلق في نفسه شعورًا نحو ما يقرؤه، قد يقوده إلى الإقبال عليه أو الإعراض عنه. والناقدُ المحايد، ومثلُه القارئ المتمرس، لا يستجيب لانطباعاته الأولى، ولا ينساق وراءها؛ فكثيرًا ما تكون خادعةً أو مضللة، ومن الأفضل أن يجعلَ بين كل قراءة وأخرى فاصلًا زمنيًّا مناسبًا؛ يتيح له أن يلتقط أنفاسه، ويستعيد هدوء العقل والنفس، وهو ما لابدَّ منه حين نطلقُ حُكمًا أو نبدي رأيًا.
وقد يفرضُ العملُ الأدبيُّ نَمَطَ قراءته وطريقة تذوقه؛ فالرواية غير القصة، والمسرحية غير ديوان الشعر، بل إن الرواية الرومانسية تختلف عن الرواية الواقعية، وهاتان بطبيعة الحال تختلفان عن كل من الرواية الرمزية والتاريخية والسياسية والبوليسية ورواية الترجمة الذاتية. ولا شك أن لحجم العمل أثرَه في عملية التلقي؛ وقد يؤدي الطولُ إلى الإملال بكثرة الحوادث وتداخل التفاصيل، كما قد يؤدي القِصَرُ إلى طمس الملامح وشحوب الفكرة. ومن المألوف أن نقرأ الرواية أو المسرحية جملةً واحدة، وأن نقرأ الديوان والمجموعة القصصية قصيدةً قصيدةً وقصةً قصة ـ اللهم إلا إذا كان الديوانُ ذا موضوعٍ واحد ـ؛ فلكل قصة فكرتها ودوافعها، ولكل قصيدة تجربتُها وإيحاءاتُها.
ولا يَخفَى على القارئ أن لدينا مشكلاتٍ كثيرةً في قراءة الأعمال الأدبية وتلقِّيها، بَلْهَ تفسيرَها وتحليلَها، منها أننا نمرُّ على النص الأدبي عجِلين، ونذرعه من أوله إلى آخره دون أن نتوقف عند شيءٍ من دلالاته أو إيحاءاته. ومثل هذه القراءة، إن صحَّت أن تسمَّى كذلك، لا تؤدي إلى ما ننتظره من مطالعة الكتب، فلا متعة بالأساليب الجميلة والعبارات الأنيقة، ولا انتفاع بالفِكَر المفيدة والمعاني العميقة، وأقصى ما نخرج به منها لا يعدو أن يكون صدى باهتًا ورَجعًا مضطربًا، لا يَثبت في ذهنٍ ولا يبقى في ذاكرة، وما يلبث مرورُ الأيامِ أن يمحوَه ويشتته كأن لم يكن؛ وما لهذا نقرأ. صحيح أن هناك من الكتب ما ينفِّرُك منه عند النظرة الأولى، ويزهِّدُك في قراءته بعد صفحةٍ أو صفحتين؛ ومثله كثيرٌ جدًّا في هذه الأيام، وهو لا يعنينا الآن، لكننا ـ للأسف طبعًا ـ مضطرون إلى أن نقرأ مائة عملٍ تافهٍ أو رديء لكي نصل إلى عمل واحدٍ جيِّد أو متميِّز.
شاعرةٌ في محراب الدعاء والرجاء:
ونحن هنا، دون أن نسبق منطق التسلسل أو نصادرَ رأيَ القراءِ، أمام عملٍ أدبيٍّ مختلفٍ عما أَلِفَهُ الناسُ بأخْرة؛ ليس في الشكل والأسلوب فحسب، بل في طبيعة التجربة ومضمونها أيضًا. وإن كان أغلب الشعراء في زماننا، وفي غير زماننا، يسيرون في الطرق السهلة المعبَّدة ويقولون في الأغراض المُعادةِ المألوفة؛ فقد اختارت الدكتورة نورا حلمي، فيما قرأتُه لها من شعر، أن تمضيَ، حتى لو كانت وحيدة، في طريقٍ صعب؛ قل عارفوه وعزَّ سالكوه. وفي الوقت الذي شُغل فيه الناسُ بالأرض وما فيها، وانصرفوا إلى الدنيا ومغرياتها، آثرت هي أن تتجه بنظرها إلى السماء، وتجعل الله عزَّ وجلَّ قِبلة قلبها وموضوعَ كلامها.
إن ديوانَها (مشكاتي)، من ورقةِ غلافِه حتى صفحاتِ محتوياته، يأخذك إلى عالمٍ آخر، ويسمو بروحك إلى معارجِ الأفق الأعلَى، وينتشلك مما غرق فيه الإنسان المعاصرُ من حاجات الجسد وشهوات النفس. إن قصائده كلَّها جاءت في مناجاة الخالق والتبتل في محرابه، دعاءً ضارعًا ورجاءً خاشعًا واستغفارًا دامعًا. ديوانٌ كاملٌ، يقع في أكثر من مائة وخمسين صفحة، ويضم بين دفتيه ما يقرب من مائة وخمسين قصيدة، تدور كلها حول موضوعٍ واحد، لا يطرقه إلا المخلصون، ولا يحسنه إلا الصادقون، ومن أخلص وصدق كُشِفت له الحجُب ورأى ما لا يراه الناظرون.
و(مشكاتي) ليس مجردَ اسمٍ للديوان، ولا مجردَ عنوانٍ لإحدى قصائده؛ بل هو المدخلُ الأكبرُ لفَهمه وتذوقه والبابُ الواسعُ لتفسيره وتحليله؛ وربما يكون مِفتاحًا لعالَم الشاعرة الفني والنفسي على حدٍّ سواء. وأذكر أنني كنت، ولا أزالُ، حين أطالع ديوانًا أو مجموعةً قصصية، أبدأ بالقصيدة التي تحمل اسم الديوان أو القصة التي جعلها القصاص عنوانًا لمجموعته. وقد يفعل الشاعر هذا لأنه يرى أن هذه القصيدة هي أجمل قصائد ديوانه، أو أنها أقرب إلى نفسه من سواها، أو أن لها مناسبةً عزيزةً وذكرى غالية، وأحيانًا يفعل ذلك لا لشيءٍ إلا لأن هذا العنوان لافتٌ وجذَّاب.
وقصيدة (مشكاتي) التي حملت اسم الديوان، وسوف نَخُصُّها هنا بوقفةٍ قصيرة، هي الخامسة في ترتيب الديوان، وجاءت في خمسة عشر بيتًا من بحر الطويل، (فَعولُن مفاعيلُن فَعولُن مفاعيلُن)، وعنوانها يستدعي إلى ذهن القارئ كلمة “مشكاة” التي وردت في قوله تعالى “اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ”. والمشكاةُ بهذا المعنى هي نورُ الله التي اهتدت له الشاعرةُ واهتدت به، أو هو كما قالت بلفط كلامها:
وذكرُك مِشكاتي وأحيا بنورِهِ ويا لَلضِّيا إنْ حَلَّ في عَينِ سَاهِرِ
والقصيدة من ألِفها إلى يائها سابحةٌ في بحر التصوف، مستغرقةٌ في عالمه الروحاني الأسمَى، ويتبيَّنُ هذا من مفرداتها (جوى، أحوال، وجْد، اشتياق، شَجْوي، الشوق، سُقيا، رَشفة، كأس، الوِصال، أُحبك حُبًّا)، وكدت أذهب إلى أنها تستلهم روح أهل الوجد الروحيِّ وتجربتهم، وتستوحي لغتهم وطريقتهم؛ لولا أنها قد كتبت لي أنها لا تذكرُ أنها قرأت لهم شيئًا يمكن أن يترك أثره فيها، وإن كانت تعرفهم حتمًا، ومن العجيب أنها لم تشغل نفسَها بالأدب الصوفي، ولم تفكر في تحديد عَلاقتها به أو المطالعة فيه؛ فهي ـ كما قالت أيضًا ـ تعبِّر عمَّا بداخلها بعفوية كاملة، دونَ أن تضع نفسَها في إطاره. وقد لا نستطيعُ نحنُ،عقلًا، أن نصدِّق هذا الأمر، أو نقْبلَه بسهولة، لكن تشابه التجارب الإنسانية قد ينتهي إلى تشابه التعبير عنها، وتقارب الأحوال الروحانية قد يثمر كلامًا متقاربًا في وقعه وإيقاعه.
والشاعرةُ في هذه القصيدة، وفي قصائد الديوان كلِّها، تستخدم ضميرَ المتكلم المذكر، ولم تُشعِرنا ولا مرَّةً واحدةً بأنها تتحدث عن تجربتها كامرأة؛ وربما يكون الحياءُ هو السبب الأكبر لهذا الأمر فهي تقول مثلًا:
أنا لو قصصتُ الليلُ يهمسُ: لا تَخَفْ دعاؤكَ موسى والمخاوف سامري
وأمشي عـــلى استحـيائيَ العمرَ كلَّه أناجِـــي وسُقيا القلب أُنسٌ بخاطري
وهذان البيتان، قبلَ أن نتجاوزَهما، يلفتان النظر بصورةٍ واضحة إلى مَلمَحٍ فنيٍّ بارز في هذا الديوان، وهو استلهام التراث وتوظيفه، إلى حدِّ التناص أحيانًا، وكان للقرآن الأثرُ الأكبر في هذه الناحية؛ فكلمة “قصصت”، وإن كانت هنا بمعنى حكيت، تعيد لنا في سياقها كلمة “قصيه” التي قالتها أم موسى لأخته، وكلمة ” لا تخف” من قوله تعالى لكليمه حين أوجسَ في نفسه خِيفةً: “قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ”. وصدر البيت الثاني ” وأمشي على استحيائي” مأخوذٌ من قوله تعالى: “وجاءته إحداهُما تمشي على استحياء”. أمَّا قولُها “والمخاوف سامري” ففيها توريةٌ طريفة؛ فهي تعني في ظاهرها أن دعاءها لله هو “موسى” النبي، والمخاوف هي موسى السامري، وتوحي بمعناها البعيد أن دعاءها لله يجعل المخاوف الموحشة أنسًا واطمئنانًا.
وهي تناجي الصاحبين على عادة القدماء في قولها:
خليليَّ في شجوي: مِدادٌ وغيهبٌ يصُبُّ المدادُ الشوقَ فوق دفاتري
وتذكِّرُنا بقول رابعة العدوية: “أحبك حبين” في قولها:
وهــــل لي بقولٍ منه قلبي يرتوي أحبُّك حُبًّا فاق ما في الضمائرِ
أحبك حبَّ الأرضِ للغيثِ بالظَّما أحبُّكَ عَــدَّ الخـلقِ معْ كلِّ ذاكرِ
أمَّا قولها:
ولا أرتجي غيـرَ الوصالِ لأنني سوى الوصلِ عندي باتَ مثلَ الكبائرِ
فيستدعي لنا قول رابعة أيضًا: “إلهي إذا كنت أعبدُك رهبةً من النارِ فاحرقني بنار جهنم؛ وإذا كنت أعبدك رغبةً في الجنة فاحرمنيها؛ وأما إذا كنت أعبدك من أجل محبتك، فلا تحرمني يا إلهي من جمالك الأزلي”. لقد اشتاقت إلى الله فأقبلَت عليه، وأحبَّت الله فطلبَت القرب منه، وعاينت جمالَ الله فأنِسَت به، وفرغت قلبها لله فلم تنشغل بأحدٍ غيره.
وهي أيضًا تتابع الشعراء الرُّوحانيين من أصحاب المواجيدِ في تعبيرهم عن الحب الإلهي، حين التمسوا ألفاظَهم وعباراتِهم من معجم الشعر الغزلي والخَمري، ولكنها لا تجاريهم في إسرافهم وشطحاتهم؛ وبدت وكأنها تطلب إلى قارئها أن ينصرفَ عن ظاهر الألفاظ الغزلية، وأن يقبِلَ على ما وراء هذا الظاهر من المعاني الخفية، التي هي أبعد ما تكون عن عالم الحسِّ وما فيه من المظاهر الدنيا، وأدنى ما تكون إلى عالم الرُّوح وما يشتمل عليه من الحقائق العُليا. وتجد مثل هذا في قولها:
فيا رَشفةً للسَّعدِ من كأس قُربِـــهِ ولستُ أبالي بعدَها في مصائري
ولا أعتقد أن قارئًا مثقفًا سوف يقرأ قولها:
جَــوَى الرُّوحِ فضَّاحٌ وليس بجائرِ كوجــهٍ وإن أخفَوه كالبدر سافرِ
دون أن يتذكر قول أحمد رامي:
الصَّــبُّ تَفضحُـــهُ عُيــــونُــه وتَنمّ عن وَجْــــــــــدٍ شُــئونُه
وإن كان كلٌّ منهما يمضي في واديه ويسرح في مَيدانه.
وفي هذه القصيدة بعضُ الصور الطريفة والاستعارات الجميلة، وهي على قِلَّتها توحي بشاعرية متميزة وتفنن بديع؛ لولا أن الشاعرة لا تقصد إليها قصدًا ولا تتكلَّفُها تكلُّفًا، وتحرص على أن تظل وفيَّةً لطريقتها التلقائية في التعبير، بغير تعمُّدٍ ولا تصنُّع. ومن هذه الصور: “جوى الروح فضاح، غاب الوجدُ واحتل ناظري، يصبُّ المدادُ الشوقَ فوق دفاتري، وليلِي إذا ما قُصَّ شوقي له انحنى، سُقيا القلب أُنسُ خواطري، ويا جنَّةً يسقِي ضياؤكَ أرضَها، تثرثرُ أنَّاتي،….”.
ولست أقطعُ أن قصيدة (مشكاتي) هي أفضلُ قصائدِ الديوان أو أعلاها فنًّا؛ ففيه الكثيرُ من أمثالها، وما قد يفوقها جمالًا. وإن تعجَبْ فعجبٌ أن تطالع ديوانًا كهذا، تدور قصائده كلُّها حول موضوعٍ واحدٍ، ثم لا يدركك مللٌ ولا سأَم، ولا يصيبك ضجرٌ ولا فتور، بل إنك تجد نفسك مستمتعةً بهذا الجو النقي الصافي الذي تحلق فيه الشاعرةُ بقيثارة فنها، شاديةً بأناشيد الدعاء وترانيم الرجاء. فتهدأ من بعد قلق، وتطمئن من بعد خوف، وتستعيد النغمَ المتبتل مرَّةً بعد مرة، مؤتنسًا بمعناه، ومنتشيًا بموسيقاه، وصاعدًا معه إلى أفقٍ علويٍّ طهور، كلُّ ما فيه يهذبك ويسمو بك.
وبمقياس الأستاذ الرافعي فإنك إذا قرأت القصيدة الزائفة أحسستَ أن في نفسك أشياء بدأت تسفُل، وإذا قرأت القصيدة الصحيحة أدركت من نفسكَ أشياء بدأت تعلو؛ تنتهي الأولى فيكَ بأثرها السيئ، وتبدأ الثانية منك بأثرها الطيب. وإنك لَتقرأ هذا الديوانَ فتكون بمنجاةٍ مما يتخبَّطُ فيه أكثر الشعراء في هذه الأيام من فوضى الغرائز والشهوات، وتشعر وكأنك صرت في دنيا غيرِ الدنيا، فعدت إلى أصل العبودية الخاضعة في مقام الربوبية القادرة، فأُخِذَت بالجلال والجمال، وغبت عن الخلق في معيَّة الخالق، وتبين لك أن لا محبوبَ إلا هو، ولا مرغوبَ إلا هو؛ لأنه لا إله إلا هو.
***
خمسون بيتًا من خمسين قصيدة :
وما إن تطالع واحدةً من قصائد الديوان حتى تقع على تشبيه معجِبٍ أو إيقاعٍ مطرِب أو معنى طريف، وإليك من ذلك خمسين بيتًا بديعًا جمعتها لك من قصائده الخمسين على الترتيب؛ وفي الديوان من أمثالها أضعافُها:
فنغــــفُــو عـــــــــلى خَمْلٍ بها وكأننا نُشِلنا من الجُــــبِّ الظليم إلى الرُّبَى
جئـــــــــتُ صَـبًّا يستــــرِقُّ الثوانــي والثــــــــــواني منه تلْــقى العُجــابا
يُلامِسُ رُوحي نفحُ أرواحِ من مضَوا ونفْسيَ من مسك المـــــلائِـــكِ تنعمُ
وتغزِلُ مُــــقلَــــتي من دمــــعِ عيني على جسد الـــدُّعَـــــا ثـــوبًا بفكري
وعِزٌّ إذا قلتُ ربـــــــي وسيِّـــــــدي تباهي به عيــــني وتزهو سـرائري
أحبُّــــكَ في شَـــــدو الأذان وعِطرهِ أُحبُّـــــكَ في نور القُرانِ وشَــــهدِهِ
وقامَ الكــــــونُ يُوقِظه خُـــضُـــوعٌ بسِربــــالٍ كســـــــــــا إنسًا وجِـــنَّا
مــــولاي بالــقلبِ المُــولَّه لـــــهفةٌ أغـفــــــــــو ولا تـغفو لبعضِ ثوانِ
لَعَمري لكَم تشقَى العقـــولُ بفِكرِها إذا لم يكُـــــــــن لله فيـــــها توهَّجــا
وتَــــــسقِـــــــي بالرضا رُوحـــي وسُــــقيــــا الـــــــرُّوحِ بـــي تَسْرِي
يأتــــي النهارُ مـع المغيبِ بلهفتـي يا لهــــفةَ النبَضـــاتِ من شـــوقٍ بِيَا
فمن حاجة الخَفَّــاقِ بــــوحٌ وقُربَةٌ بليلٍ يُذيبُ النــــورَ في غَور أضلُعي
ليـــتَ العَـنادلَ فـــي كفوفي سُبْحةٌ تشــــــدو بتسبيـــحٍ يــــليــــه ثــــناءُ
والســــــاهرون بِحُبِّ مـولاهم إذا حـــلَّ الصَّبـــاحُ كأن خِـــلًّا ودَّعــــا
وإن سكبَت عيني إليــــكَ دموعَها بقلبي سكبتُ الحُـــــبَّ بالنـور سـاقيا
أنا ما أتيتُ الآنَ فــــي سُؤْلِ زينةٍ ولكن بسُؤلي قــــد تَـــــزيَّنَ مَسمَعي
تاللهِ لو صُبَّ عمرُ الناسِ فــــي عمري لما كفاني الـــدعا لــــــو سال كالدِّيَمِ
أخفي وتعلمُ مـــــا يحيِّرُ عُـــوَّدي والــــرُّوح تــــعلمُ أنَّ مــولاها لـــها
الخلقُ والأكـــــــــــوانُ كلُّهمُ فَـمٌ لك سبَّح الفَــــم والقُـــــلوبُ جـــــباهُ
تصطفُّ كل الكائنات وشــــدوُها بالذِّكــــرِ فـــــي أذْني وقــلبي بُلـــبُلُ
فأنت الله تكفيـــــــني وحَسبـــــي بأن الله أهــــــــــدَى القلـــــبَ ذِكـرا
وفي قلبيَ المِكتامِ ذِكـــرٌ ومسجـدٌ وتِهمالُه يُــــدمِي ويُطفي ويُخـــــرِبُ
الله أكبرُ سَـــــلســالٌ روَى بَــدَني الله أكــــــبرُ مَنجـاةٌ مـن المِحــــــــنِ
ومِن حبِّك المنثورِ فــي عُمقِ مهجـَتي يُـــــذاعُ بــذي الـــدنيا شذاهُ ومـــا بِيا
وجْــدي إليكَ وليس عندك ـخافيا وتَدَثُّري باللطفِ يُبْـــــــــدي مــــا بيا
سَطـــا شوقي لسطوةِ ذا الجـمالِ بأسماءِ الكــــــريمِ وذي الجــــــــلالِ
وفي القلبِ بستانٌ وعُشٌّ به شدت عنـــادلُ فـــي ظِـلِّ التواشيحِ ترقُــــدُ
ومُوقِـــدُ شمعي في الحنايا تَحَنُّنٌ تُضاءُ بـه نفسي متى الليــــــلُ أظلَما
وإني بِـــــــــذي الدنيا فناءٌ بعينِه ولكنْ بعيني ذاك عَيــــنُ حــــياتِــــيا
مِدادٌ من النورِ المحبَّرِ في الدُّجَى يضيءُ متى أبْـــــدي بقولــــي وأكتُمُ
يا لِلَّيالي لو أبــــــــــوح بِحَكْيِها كم حدَّثتني عنك بالجُـــــودِ الدُّنَــــــى
سبحانَ من سجدَت له أكـــوانُهُ وأعــزُّ ما فيـــــــها جبينُ الســـــاجدِ
كأن فؤادي قرصُ شمسٍ متى دعـا تجَـلَّى عـلى سُحُبِ السكوتِ بـــنورِه
ولقد لبِسْتُ الوَجــدَ مُذْ عرَّفتَني بالجُــودِ منــكَ وليس ذاك بِمِغْـــزلــي
كغمامةٍ قـــادت غمامًا ممطِرًا وأَجَــــلُّ ممــــا لاحَ غُيِّــبَ أكـــثَـــرا
نفسي من الإنسِ إلا أنها سكنَت بالأُنسِ بيتًا بسُحـبٍ مـــــا له عَمَـــــدُ
أمَا افتقرَ المكَّارُ بالمَكْرِ والخَنا وللسُّمِّ طـــــبَّاخٌ السُّـــــــمومِ تـــذوَّقَــا
مخضَلَّتانِ عيـــــــونُه قد حثَّها شَجوٌ بحَـــرفي فوق فرحي أُســــــدِلا
وخلعتُ صمتي عند بابِ وصالِهِ ولبِسْتُ ثـــــوبَ دعــائهِ ونِـــــــــــداهُ
لَعَمري لئن حارَ الفؤادُ بوصفِها فقد أبصرَت رُوحي ســـــناها كما هيا
أقسمتُ يا قلبي عليك علانِــيَـه أن طالما تحـــــــيا تـــؤوبُ بــــما بِيَه
والبَوحُ لا يَنفَكُّ يُشعِلُه الجـوَى دمعًـــا وصمتًا لو خـــبا الإفصــــــــاحُ
إنَّ الفـــــــــــؤادَ بليــلهِ متدثِّرٌ كالبيتِ فــــــي زيِّ الســـــــوادِ تقـــيــهِ
وقد كان مخبوءَ الجوانبِ خافقي فشــــدَّ اللثامَ الوجـــــــــــدُ عـمَّا تكتَّما
لأن رضاكَ السُّؤْلُ قلت سأسأَلُ أُجَمِّلُ سُـؤْلي والرضــــا منـكَ أجــملُ
ما أعذَبَ القولَ في جنبي أُخبِّئُه حتى يُصَبَّ بكأس اللـــيــلِ إن هجعــا
أَفِــــرُّ من الدنيا كأنّي وأرضَها خُــصُومٌ بقلبٍ في عُــــــلاكَ مُـثابــــرِ
***
أصداءُ القرآن في أبيات الديوان:
أشرتُ من قبلُ إلى ما في الديوان من تاثرٍ واضحٍ بالقرآن الكريم، لفظًا ومعنى، وليس هذا بمستغربٍ على شاعرةٍ تعيش في ظلاله وتحيا في أنواره؛ فهي تحفظه نصًّا بقراءاتٍ عدَّة، وتقوم على إقرائه وتعليمه في مدينة النبي الأكرم، وبَدَهيٌّ والأمرُ هكذا أن يكون للقرآن صداه الجليُّ في أكثر قصائد الديوان، شعوريًّا كان ذلك أو لا شعوريًّا، وهو عنوانٌ على صدق التجربة الرُّوحية وعمقها، وتأكيدٌ على مذهب الشاعرة في تزيين كلامها بقبسات من وحي ربها. وسوف أُثبِتُ هنا، تمثيلًا لا حصرًا، طائفةً من تعبيرات الشاعرة وما تستدعيه من آيات كتاب الله، وفي الديوان كثيرٌ غيرُها لم يريد أن يستزيد:
هو نورٌ والدُّنى منه نورٌ : “الله نور السماوات والأرض”.
ومولاي المحيطُ بكل أمري : “والله بكل شيءٍ محيط”.
وبسم الله مُجري بي يقيني : “باسم الله مجريها ومرساها”.
وإنَّا راجعون إليه إنَّا : “إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون”.
لأنكَ ربي من وريديَ أقربُ : “ونحنُ أقربُ إليه من حبل الوريد”.
ولم تتخذ يا واحدًا ولا .. بصاحبةٍ ترضَى : “لم يتخذ صاحبةً ولا ولَدا”.
عَنَتِ الوجوه لنور وجهك سيدي : “وعَنَتِ الوجوهُ لِلْحَيِّ القيوم”.
ولذا عجِلتُ إليكَ حتى ترتضي : “وعجِلْتُ إليكَ رَبِّ لترضَى”.
لم أستطع صبرًا على صمتي : “إنك لن تستطيع معيَ صبرًا”.
وعليك تُكلاني وما خاب الذي * قد قال يا ربي عليك توكلي : ” وعلى الله فلْيتوكَّلِ المتوكلون”. ” وعلى الله فلْيتوكَّلِ المؤمنون”.
ولسوف يعطي الله قلبي سُؤْلَهُ : “ولسوفَ يعطيك ربُّكَ فترضَى”.
ما ودَّعَ المولَى المجيبُ وما قَلَى : “ما ودَّعَك ربُّكَ وما قَلَى”.
لا أبرح الأبوابَ إن لم تنفتح : “فلن أبرَحَ الأرضَ حتى يأذنَ لي أبي”.
والقلبُ فرَّ إلى الركن الشديد ومن * آوَى إليه .. : ” قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ”.
 شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..شبكة إخبارية تتيح مساحة جديدة للمعرفة والإبداع والرأي حول العالم..
شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..شبكة إخبارية تتيح مساحة جديدة للمعرفة والإبداع والرأي حول العالم..