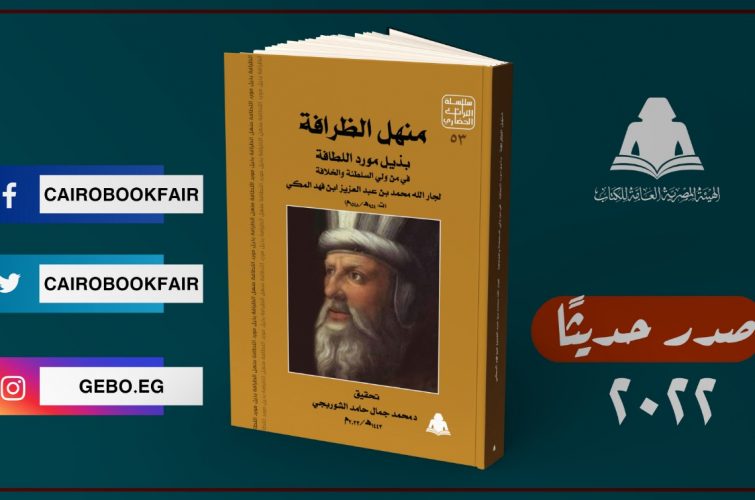يقدم الموقع الإخباري الرسمي لهيئة الكتاب ومعرض الكتاب قراءة الناقد مجدي نصار للمجموعة القصصية “الجو العام” للكاتب إبراهيم داوود.
في إعلان قديم، يقول الفنان عادل إمام، واصفًا المواطن المصري، ابن الأغلبية الشعبية: “بسيط .. وعلى قدْ بساطته، ملك!”. ترددت هذه الجملة برأسي كثيرًا بينما أقطع شوطًا خلف شوط في المجموعة القصصية “الجو العام” للكاتب والشاعر إبراهيم داود الذي يراهن على البساطة والاختزال، كسلاحين رئيسيين للقص، عبر ثمان وثلاثين قصة تتأمل الجو الخاص لأبطالها، وتربطه بالجو العام، العالمي والقومي.
يصحبنا إبراهيم داود في جولة جغرافية وتاريخية ونفسية يضيء فيها المصابيح في ليالي القاهرة، يعانق نهاراتها، يطرق أبواب البيوت بخفة ودون أن يزعج أصحابها، يصاحب الناس، يتأمل السنين، يفتح صناديق الحكايا وألبومات الصور، يُشغِّل أشرطة الكاسيت، يقفز من عِقد إلى عِقد في كتاب التاريخ، ومن بداية إلى وسط إلى نهاية في حيوات أناس عرفهم وعاشرهم.
ترتكز القصة عن داود على الحكاية “الشفاهية”، بالأساس، وتتناولها في قالب قصصي متناغم. تتجلى مهارته كحكاء ممتاز، بإمكانه أن يتوسط جمعًا من الساهرين فينسج حكاياته على طريقته البسيطة، بصورة تمزج الطريقة الشعبية بالطريقة الصحافية، يميزها إنها تتجاوز التقريرية إلى الأدبية، إضافة إلى كونها محملة بالخفة والرشاقة والصور والمشهديات.
تمثل مجموعة “الجو العام” نوستالجيا يمكن وصفها بالمسرحية، إذ ينفتح الستار القصصي عن خشبة يحتلها شخص أو شخصان، سرعان ما تتبدل الخلفية والمشهد فينضم آخرون، يمنحون القصة مزيدًا من الأحداث. كما أنها نوستالجيا فنية وغنائية. فلدينا توثيق لتاريخ الفنون والمدارس الفنية وأعلامها. كما لا تغيب الموسيقى عن السرد الذي يتحرك أصلا على إيقاع موسيقى ذاتية تقبع في نفس الكاتب.
يعتمد داود على البناء العادي، المرتب والكلاسيكي في أحيان كثيرة. يبتعد عن البناءات المعقدة، الغامضة أو الدائرية أو المقلوبة. يؤمن أن كل السحر في البساطة. وعلى مستوى الشكل الكتابي، ينهي أغلب الجمل بفاصلة عوضا عن النقطة، ما يسمح له بالاسترسال في الحكي دون توقف، وما يؤكد إن حكاياته لا تنتهي في العموم وإنه يحرص على تحريك الحكاية في نسق متدفق أكثر من حرصه على إحكامها أو غلقها تمامًا بالشكل التقليدي.
يستغل داود اللغة السليمة “الواضحة”، البعيدة عن التقعير، يمزجها بالعامية “الدالة” التي تمنح القصص “خصويتها المصرية” وتفتح للقاريء أبوابًا يتعرف من خلالها على مفردات تلك الخصوصية. يحدثنا عن “كاسيت بروحين”، عن شخصين عادا من زيارة “تمام التمام التمام”، عن “مصطفى” الذي هو “ابن ليل، مائي وهوائي، أي يشرب الخمر والحشيش”. يكتب إبراهيم السرد كما يكتب الشعر، ببساطة محملة بالمشاعر والأحاسيس عوضا عن المعاني الكبيرة، التي قد تخرج جوفاء في الغالب.
يصنع الصورة القصصية بأقل التكاليف اللغوية. يقول مثلا: “طرق كمال باب توفيق بيده وعلى الجرس وبقدمه كما كان يفعل قبل خمس سنوات”. ويقول أيضًا إن فلانًا “متزوج من امرأتين، إحداهما (وأجملهما) سودانية”.
كما يعتمد على “التوليد اللغوي” من “قماشة الموقف القصصي”؛ فلدينا شخصية “تكتب عن مسرح الشعب، بعد القضاء على المسرح والشعب”، وشخصًا “أعطوه شيكا بعشرين ألف جنيه وجعلوه يوقع على عشرين ألف ورقة” وآخر “رحب به الشباب وسخر منه الشيوخ واستغربه القهوجية”، وشخصًا “يعزم على الجميع والكيس في يده وفي النهاية يلتهمه بمفرده”.
يختار داود الكلمة بعناية ودقة. يتحدث مثلا عن صديقان “إذا دخلت (فيهما) ستكتشف إنهما مختلفان تماما”، لم يقل “بينهما” بل “فيهما”، ما يعكس الدلالة التي يريد الوصول إليها.
تتجلى اللمحة الوجودية في اختيار أسماء الأبطال كعناوين لأغلب القصص، ما يضمر إيمانا بالناس ومحبة عميقة لهم في نفس الكاتب. فالبطل هنا هو الحكاية أو لنقل إن الحكاية لا قيمة لها دون قيمة البطل، الإنسان.
يحدثنا إبراهيم داود عن أشخاص عاديين، ليسوا ملحميين، لكنهم أبطال بحق في عوالمهم الصغيرة. يتجول بين صوفيين وفنانين وصعاليك وأنصاف صعاليك، يتأثرون بالعام ولا يستطيعون التغيير إلا في ذواتهم. أشخاص تؤلف الأحداث بينهم، تجمعهم السياسة أو تفرقهم، تضمهم الأذواق الفنية أو تباعد بينهم، قد تجمعهم الصدفة ويتفرقون بلا حدث ضخم.
يحدثنا عن أشخاص يمارسون الجنون على طريقتهم الخاصة، جنون اختياري، يعيشون سعداء ويموتون سعداء. أحدهم يسأل قطعة حشيش قبعت في بذلته منذ السبعينيات: “أنا فاكرك، إنتي فاكراني؟”. يحدثنا عن “توفيق” الذي يشعر بإنه إنسان فاشل إن مشى في الشارع بدون ولاعة، عن واحد أصبح يكلم الهواء كالمجاذيب، وآخر يعيش في شقته مع العفاريت. عن ذلك الذي “اختفى ثم شوهد بعد سنوات ينظم المرور بنفسه في مدينة 15 مايو”. عن صديق خاصم صديقه لأنه تخلى عن مساعدته في حلم! عن “تاح” الذي إذا مرت به سيدة جميلة تشعر إن الدموع ستنزل من عينيه. يروي داود حكاية شاعر، في زمننا هذا، يكتب قصائد تقليدية تعود إلى عصر عتيق، يهاجم فيها الوالي والعسس بسبب اضطهادهم للرعية! وحكاية رجل مصري حين يسكر يتحدث بلهجة سعودية، وعن شاعر كتب لحبيبته إنه لن يكمل حياته معها وفي اليوم التالي تقدم لخطبتها. كما يحدثنا عن صوفي غَيَّر اسمه من “محمود” إلى “العبد” لأنه لا محمود إلا الله.
يربط داود العام القومي بالشخصي المتحرك داخل الفرد أو بينه وبين دائرة أصدقاءه. يتناول تأثير الأحداث السياسية العالمية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على حياة الأشخاص. في قصة “حمدي”، اعتبر البطل انهيار الاتحاد السوفيتي هزيمة شخصية. في قصة أخرى، توقف شخص عن التدخين وهو في الخامسة والخمسين وعاد إليه بعد غرق العبَّارة المصرية. في قصة “إدريس”، لدينا “جامعة دول عربية” في البار، يقول داود في نهاية القصة “وخرجت الأمة العربية من القسم وبقى هو على ذمة التحقيق.”
مع هذا الحرص على الكتابة ببساطة، لا يهجر الكاتب المجاز والأوصاف الدالة. يصف إحداهن بقوله “كانت ممتلئة امتلاء محمودًا ويغطي الشجن ملامحها الدقيقة.” يصف الطبيب بأنه “لا يخلو من طيبة قديمة”. هذه “على ملامحها غلظة بدائية” وهذا “يدخن الشيشة كما عربية بطاطا”. وآخر “كان مبهورا ومسطولا ومستريبا وقلقانا وفرحانا”. يصف “قدري” قائلا: لا تستطيع أن تكرهه ولا تستطيع أن تأمن له، ولا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال. يقول في وصف المخرج والرسام، “المخرج يبدو قصيرا وهو ليس كذلك، والرسام يبدو طويلا وهو بالفعل كذلك. شخص ما “يفهم في الخشب والفضة والزجاج والناس” وآخر “يرتبك أمام أي تاء تأنيث”. هذان “توجد بينهما غتاتة متبادلة” وسائق التاكسي “رَشَّ بهجة على المكان”.
يضفي الكاتب على حكاياته الواقعية “لمحة فانتازية” يستعين فيها بقدرته على التخليق القصصي. فمثلا يستحضر صورة احتفال اللاعب الإيفواري دروجبا ويجعل “حمدي” يحتفل بفوز مصر ببطولة الأمم بنفس الطريقة. كما يتناول زلزال (1992) في مشهد انتقل من الواقعية إلى ما يشبه الفانتازية، إذ رأى بطل القصة العمائر وهي ترقص “أحس فجأة إن العمارتين الكائنتين أمامه ترقصان”.
للمكان حضور كبير في القصص، فشخصياتنا مغايرة، تحتل أماكن تشبههم، يختارونها بعيدة أو منعزلة ويعيثون فيها فوضى وحرية. يقول عن أحد تلك الأماكن: “دائما الصعود إلى سطوح عز يعني إنك ستكون في حال أفضل”
يبدع داود في الانتقاء الحَدَثي والقفز الزمني. يستعرض من الحياة الطويلة للشخصية ما يفيد القصة ويستبعد الأجزاء التي لا تضيف شيئًا. ينتقي المواقف التي تعكس طبائع الشخصيات. يقول في إحدى القصص “كيف حدث هذا؟ هذا ما حدث!” ثم ينتقل إلى المهم من الأحداث. يبتعد عن التبرير والتفسير، يؤمن بالحكاية نفسها لا بفلسفتها.
يلجأ داود للنهايات الصغيرة المفتوحة ويبتعد عن النهايات المحكمة المعتمدة على استنباط العظة أو الدرس. تنتهي القصص بوحدة، ببكاء، بوفاق بعد خصام، أو بفراق بعد وئام. ينهي القصة بطريقة تسمح لخيالك باللهث وراء البطل ومحاولة استكشاف ما تبقى من حكايته بعد الحادث القصصي. يموت الناس ببساطة كما يعيشون ببساطة. الحاج فريد “أكل طعام أمه وأشعل سيجارة ومات”. “الجنايني” “فرد جسده وأطلق الشهادتين ومات”. وآخر “عندما أحس بمنزلته في قلوب معظم المحيطين به، توكل عل الله” كما أن الأشخاص يتصرفون حيال الموت ببساطة تضاهي بساطة حدوثه، فحين مات أحد الأبطال، “انزعج عز الدين، وابتسم العبد وجلس فوق رأسه يقرأ القرآن”.
وأخيرا يمكن وصف المجموعة بأنها “رحلة في الزمن”، تناول فيها داود لمحات من حياة المجتمع المصري في الحقب الفائتة، لمحات مُعَبِّرة، انتقاها بقصدية الكاتب وبعفوية الفنان.
 شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..شبكة إخبارية تتيح مساحة جديدة للمعرفة والإبداع والرأي حول العالم..
شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..شبكة إخبارية تتيح مساحة جديدة للمعرفة والإبداع والرأي حول العالم..