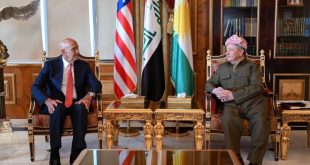الدكتور غانم السعيد يكتب: السوشيال ميديا وفواجع العصر الكبرى
حين أطالع صفحات التواصل الاجتماعي، لا أقرأ أخبارًا عابرة بقدر ما أفتح نوافذ على كوابيس إنسانية، تتتابع فيها الجرائم الغريبة كأنها مشاهد من رواية سوداء، لا من واقعٍ كان يُحسب له حساب القيم والروابط والرحمة. جرائم تهزّ الوجدان قبل أن تصدم العقل، وتترك في النفس سؤالًا مُلحًّا لا يهدأ.
أبٌ يُعذّب ابنته بالجوع حتى الموت، لا لذنب اقترفته سوى أنها وُلدت ضعيفةً تحت سقف قاسٍ.
وابنةٌ ترفع يدها على أبيها لأنه حاول — في منطق الأبوة — أن يمنعها من الزواج بمدمن مخدرات يكبرها بسنوات، خوفًا عليها لا تسلّطًا عليها.
وزوجٌ لا يكتفي بالقسوة، بل يرسل صديقه إلى زوجته لينال من شرفها، لا بدافع شهوة، بل بدافع الحساب البارد، حتى يجعل من الجريمة ذريعةً للطلاق، ويبرّر سلب الحقوق، وكأن الأخلاق بنودٌ في عقد قابل للتحايل.
وأبٌ آخر يقتل زوجته وأطفاله دفعة واحدة، بحجة الخوف من الفقر، ناسفًا بفعلته كل معنى للتوكّل، وكل يقين بأن الله هو الرزّاق لا السكين.
وأم تقتل ابنها خشية أن يكشف سترها، فتفقد معنى الأمومة التي تفوق أي معنى إنساني.
وعريسٌ يحوّل ليلة الزفاف إلى جنازة، فيقتل عروسه في ثوبها الأبيض لسبب تافه، فتختلط الزغاريد بالصراخ، والفرح بالدم.
وزوجةٌ تقتل زوجها لأنه طلب منها إعداد الطعام، وهي في أشهر حملها الأولى، فتتحوّل التفاصيل اليومية البسيطة إلى شرارة جريمة.
أمثلة تتكاثر حتى يعجز القلم عن الإحاطة بها، ويقف العقل مذهولًا أمام هذا التوحّش الذي لا يُشبه ما ألفناه في مجتمعاتنا، ولا ما تربّت عليه أجيالنا من حرمة الدم، وقدسية الأسرة، وهيبة الروابط الإنسانية.
وهنا يتسلّل السؤال الثقيل إلى النفس:
هل كانت هذه الجرائم موجودة من قبل، ولكنها كانت تُرتكب في الظل، وتُوارى تحت سجاد الصمت الاجتماعي، فجاءت وسائل التواصل الاجتماعي فكشفت المستور، وعرّت القبح، وأعلنت ما كان يُخفى؟
أم أننا أمام خللٍ أخلاقيٍّ عميق، وجهلٍ دينيٍّ فادح، وتآكلٍ بطيء في منظومة القيم، جعل الجرأة على القتل، والاعتداء، والخيانة، أسهل من الجرأة على الصبر، والحوار، والاحتواء؟
لعلّ في الأمر شقّين معًا: فالسوشيال ميديا لم تخلق الجريمة، لكنها منحتها منبرًا، ووسّعت دائرة انتشارها، وجعلت الفرد يعيش داخل سيلٍ يومي من العنف، حتى يألف المشهد، ويبرد الإحساس، ويختلّ ميزان الاستنكار. غير أن هذا لا يُعفي المجتمع من مواجهة الحقيقة الأشد مرارة: أن الفراغ القيمي حين يتمدد، لا يترك خلفه إلا وحوشًا بشرية تمشي على قدمين.
حين يغيب الوعي الديني الصحيح، ويُختزل الدين في طقوس بلا روح، أو شعارات بلا أخلاق، وحين تنهار التربية الأسرية، وتضعف المدرسة، ويتراجع الخطاب الثقافي الرشيد، يصبح الإنسان فريسة سهلة لغضبه، ونزواته، وأفكاره المريضة. عندها لا يعود الأب أبًا، ولا الزوج زوجًا، ولا الابن ابنًا، بل يتحوّل الجميع إلى أفراد معزولين، تحكمهم شريعة القوة والانتقام والخوف.
وإذا كان الأمر كذلك — وهو كذلك في كثير من مظاهره — فإن المواجهة لا تكون أمنيّة فقط، ولا قانونية فحسب، رغم أهميتهما، بل هي معركة وعيٍ في المقام الأول. معركة تشترك فيها مؤسسات التعليم، والمنابر الدينية، والإعلام، والأسرة، وكل من يملك كلمة أو تأثيرًا. فالقانون يعاقب بعد وقوع الجريمة، أما الوعي فيمنعها قبل أن تولد.
إن أخطر ما في هذه الجرائم ليس عددها، بل اعتيادنا قراءتها دون أن نرتجف كما ينبغي، ودون أن نسأل أنفسنا بصدق: أيّ مجتمع نصنع؟ وأيّ إنسان نُخرِج؟
فحين يفقد الإنسان إنسانيته، لا تعود الجريمة استثناءً، بل تصبح خبرًا عاديًا في شريط الأخبار… وتلك هي الفاجعة الكبرى.
*الكاتب أستاذ الإعلام – العميد الأسبق لكليتي الإعلام واللغة العربية بجامعة الأزهر
 شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..موقع ينقل المعلومة والخبر من كل مكان في العالم وينشر المعرفة والإبداع
شبكة عالم جديد الإخبارية عالم جديد..موقع ينقل المعلومة والخبر من كل مكان في العالم وينشر المعرفة والإبداع